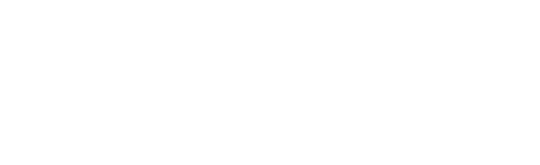الغازي لكبير، يكتب: “التفاهة هلاك”.
أصبحت التفاهة في المجتمع المغربي من أبرز الظواهر التي تستوقف المتأمل، فقد بلغت السطحية والابتذال وغياب العمق في الفكر والسلوك والخطاب درجة تشكيل الوعي الفردي والجماعي. بالرغم من أنها في الأصل تعود إلى ما هو قليل القيمة، وضعيف الأثر، والذي لا يُعتدّ به في أي شيء!
نشأ تضخيم المحتوى الفارغ ومنح الشهرة لمن لا يملك قيمة معرفية أو أخلاقية بداية، من تراجع دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية مثل الأسرة والمدرسة وجمعيات المجتمع المدني التي كانت تساهم كل واحدة منها من منظورها الخاص في غرس القيم الأخلاقية وبناء الوعي النقدي. وبعد ذلك، وإضافة إليه، انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سريع. هذان العاملان بشكل كبير، فضلا عن عوامل أخرى، جعلا التفاهة تنتشر بشكل سريع وواسع بيننا.
وتتخذ التفاهة هذه مظاهر متعددة وأشكال متباينة في المجتمع، منها تفاهة الخطاب الذي يُكثر من الضجيج والبهرجة بدل الوضوح ويركز على العرض والاستعراض بدل التحليل، حيث يسود الكلام الفارغ على حساب الفكر الرصين.
وتفاهة السلوك، حين يصبح الاستهزاء بالقيم والجدية مدعاة للضحك والتسلية. ثم تفاهة الإعلام (وما أكثرها للأسف)، من خلال تسويق الرداءة وتهميش الكفاءة.
هذا النوع الرخيص من الإعلام الذي يغيب وعي المجتمع ويساهم في تدهور قيمه، يركز على الاثارة والفضائح، بل يضخم أحداثا بسيطة من أجل الرفع من المشاهدات في وسائل التواصل الاجتماعي أو من أجل التضليل والإلهاء. وتتخذ التفاهة الإعلامية أحيانًا شكل الدفاع عن النفس، إذ يلجأ الفرد الذي يشتغل في المجال إلى السخرية والاستهزاء لتجنب مواجهة الإحباط أو الفشل.
وبانشغال هذا النوع من الاعلام بالمظهر بدل الجوهر، وبالشهرة بدل الاستحقاق ينحرف عن هدف الاعلام المسؤول الذي يتجلى أولا وأخيرا في نشر الوعي والمعرفة.
والتفاهة في أشكالها المختلفة وفي مظاهرها المتباينة تُفرغ الإنسان من المعنى، وتضعف قدرته على التفكير النقدي والتحليل العميق، وتزرع اللامبالاة وتُشجع على الكسل الفكري والاكتفاء بالأسهل والأسرع تماما كما نلاحظه يوميا.
أما على مستوى المجتمع، فتؤدي التفاهة إلى تراجع القيم، وتشويه الذوق العام، وإضعاف الثقة في المعرفة والعلم،
كما تُعيق التنمية، لأن المجتمعات التي تُمجّد التفاهة تُقصي الجدية والإبداع والتميّز، وتتخلى عن الانسان الذي لا تنمية بدونه.
أما العلاقات في ظل التفاهة فهي تُبنى على الصورة لا على القيم، أما الثقةُ الاجتماعية فتُؤسَّس على ضبابية الحدود بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول مما يجعل الغموض سيد الموقف.
وليست التفاهة سلوكا عابرا، بل هي نظام اجتماعي وسياسي أصبح ثقافيا وصار منظما، لذلك فإن مواجهتها تتطلب معالجة عميقة لعلاقة الفرد بذاته وبالمجتمع، معالجة تضمن توازنًا نفسيًا وتماسكًا اجتماعيًا. ويقتضي مثل هذا الاجراء تعزيز الصحة النفسية وبناء هوية متوازنة لدى الأفراد.
من هذا المنطلق يصبح التصدي للتفاهة أمرا ضروريا ومستعجلا، لكونه يهدد الوعي والقيم، ويحول الاهتمام من الجاد والمفيد إلى السطحي والمستفز ويشجع على استهلاك المحتوى الزائف بدل القَيِّم والأصيل.
ومن بين سبل محاربتها يمكن اللجوء إلى تربية اجتماعية تجعل من الوعي الاجتماعي هدفا استراتيجيا عبر إرساء حماية وحصانة مجتمعية عن طريق تغيير نمط الاستهلاك وذلك بتشجيع المحتويات الثقافية والفنية الجادة وترسيخ ثقافة الجهد والمسؤولية والتفكير النقدي من جهة، ومن جهة أخرى، الكف عن التفاعل الايجابي مع كل ما هو رديء وكل ما من شأنه أن يجعل من الفرد مستهلكا سلبيا.
إن التفاهة سرطان في دم المجتمع، ينخره، يضعفه، يقتله.
فإلى متى سنظل نستهلك السطحية في الخطاب والسلوك؟
وإلى متى سنظل نؤجل بناء الفكر والوعي الجماعيين؟
وهل نستطيع يوما التحرر من منطق التفاهة ومراجعة القيم السائدة لتستعيد الجدية مكانتها بيننا؟
“””الغازي لكبير “””